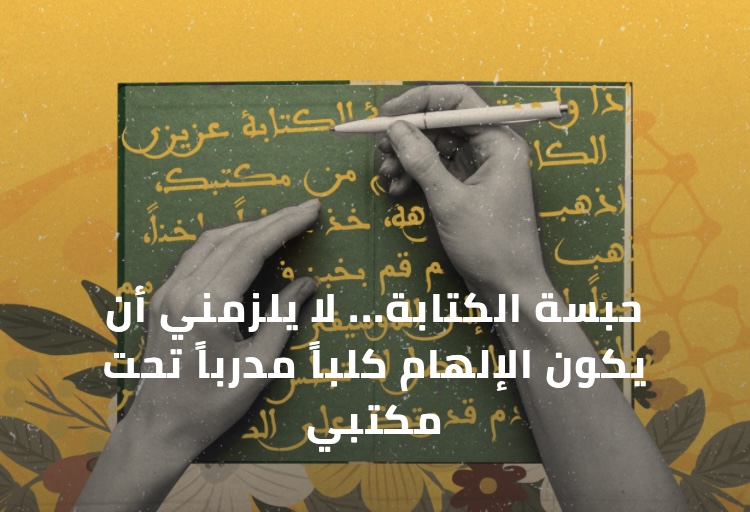كيف أنقذني الشِّعر من التطرّف والجنون والموت؟

09/08/2021
1644 كلمة
* ملاحظة: يتناول هذا النص مواضيع قد تكون حساسةً لبعض القارئات والقرّاء، مثل الاكتئاب ونوبات الهلع والانتحار.
المدينة هادئة، الأبواب مغلقةٌ دائمًا، والشوارع خاليةٌ من الناس في معظم الوقت. لا شيء فيها سوى سيارات متحركة. حتى حين تحاول النظر إلى داخل السيارات للتعرف إلى ملامح من فيها، فلن تقدر على ذلك لأن النوافذ تكون مظللةً غالبًا، كما أن النساء في الداخل يلتحفن الأسود. هكذا أستطيع أن أصِف البلدة التي نشأتُ فيها، وأظن أن حياتي هناك كانت مرادفةً للعزلة. أنتِ معزولةٌ عن الحياة، والنَّاس والطرقات، والجميع معزولون عنكِ، كأنك تشاهدين الحياة من خلف زجاج.
كتبتُ ذات مرة: “يظن الناس أنك لا تشعر بالاكتئاب عندما تكون طفلًا، لكني شعرتُ به. كنت في التاسعة من عمري وكنت أحسّ بحزنٍ شديدٍ كلما سمعتُ صوت البحر في أذني، ثم تذكرتُ أنه بعيدٌ جدًا”. كنتُ مُرغمةً على صنع عالمٍ يخصّني، ما دامت الحياة في الخارج لا تشبهني ولا ترحّب بي.
تقول أمّي إنّي كنت طفلةً مشاغبةً لا تكفّ عن افتعال الشجار مع الجميع، لكن كلّ ما أذكره عن نفسي هو أنني كنتُ في غاية الوحدة، لذلك لجأتُ إلى الشِّعر باكرًا. أردتُ أن يكون لي صوت، وصديقٌ أتحدث إليه، وأطفالٌ ألعب معهم، ولغةٌ أفهمها وأنتمي إليها، وبلدةٌ أكبر فيها من دون تنمّرٍ وسخريةٍ وأحكامٍ مُسبقةٍ وعباءاتٍ سوداء.
داخل مدارس تحفيظ القرآن
قرّر والدي في السنة الأخيرة من المرحلة الابتدائية إلحاقي بإحدى مدارس تحفيظ القرآن لضبطي والسيطرة عليّ. كنا نعيش أساسًا في منطقةٍ متزمتةٍ في السعودية، لذلك لم يكن هناك فرقٌ كبيرٌ بين مدارس تحفيظ القرآن والمدارس الأخرى. ففي المدارس العادية التي درستُ فيها، فُرضت علينا العباءة وغطاء الوجه من المرحلة الابتدائية، أمّا مدارس التحفيظ ففرضَت علاوةً على ذلك تغطية اليدين والقدمين.
تعرفتُ إلى العديد من الفتيات المتديّنات، وبدأتُ أجلس برفقتهنّ في الصفوف الأولى لنتبادل الأشرطة الدينية ونتحدث بحبٍّ عن الحجاب والصلاة. كانت صديقتي المقربة ابنة إمام المسجد، وكانت تُحضر لي العديد من الأشرطة والمحاضرات التي سرعان ما بدأتُ أتأثر بها.
لم أكن تجاوزتُ الرابعة عشرة عندما بدأتُ بتفريغ محتوى الأشرطة الدينية وكتابته ثم حفظه. ولأني كنتُ ذكيةً وسريعة الحفظ بشكلٍ ملفت، تبنّتني جماعة المصلّى في المدرسة، ثم بدأتُ بإلقاء المحاضرات الدينية في وقت الفسحة.
في المدارس العادية التي درستُ فيها، فُرضت علينا العباءة وغطاء الوجه من المرحلة الابتدائية، أمّا مدارس التحفيظ ففرضَت علاوةً على ذلك تغطية اليدين والقدمين
كان أسلوبي في الخطابة مؤثرًا، كما كان صغر سني وقدرتي على الحفظ والإلقاء عاملًا مهمًا لتأثر الأخريات بي. وفي تلك الفترة، اعتدتُ الحصول على الكثير من الإطراء من الفتيات والمعلمات، كما كنتُ مضرب مثالٍ في المنزل وفي محيطي: أراد الجميع أن تصبح بناتهنّ مثلي، ما جعلني غير محبوبةٍ وعاجزةً عن تكوين صداقاتٍ حقيقية.
كان كل شيءٍ يسير على ما يرام؛ عائلتي راضيةٌ عني لأنّي صرتُ مؤدّبةً وتمكنّتُ في سنواتٍ قليلةٍ من حفظ القرآن بالقراءات العشر، والمعلّمون في المدرسة يُحبّونني والفتيات مُنبهراتٌ بي دائمًا. كان كل شيءٍ بخير، لكنّني كنتُ حزينةً للغاية، وكنتُ أنظم الشِّعر سرًّا.
الاحتماء بالحلم
أخذني الشِّعر إلى عوالم أخرى لم أكن أعرفها من قبل. صرتُ أقضي وقتًا طويلًا بمفردي، أتأمل السماء وأشعر بروحي تزداد اتساعًا وتتواصل مع الرب من دون حواجز. صار يومي الثقيل والطويل طافحًا بالأحلام والخيال والأفكار الغريبة، حتّى أنّي في إحدى المرّات قلتُ لوالديّ إنّي عشتُ حياةً أخرى قبل هذه الحياة وإنّي في الأصل رجلٌ عجوز.
كان قلبي متصوفًا، ورغم كل محاولات التديّن التي انصعتُ إليها في مرحلةٍ ما، كان في داخلي شيءٌ ما يرفض ما يحدث، ويشتاق إلى التحدث مع إله طفولته الذي اكتشفَه بمفرده، وكان يقضي ساعاتٍ وساعاتٍ في مناجاته والشكوى إليه.
في نهاية المرحلة الإعدادية، توقفتُ عن مرافقة الفتيات المتديّنات أو الجلوس في الصفوف الأمامية، ثم انتقلتُ إلى مرافقة الفتيات اللواتي اعتَدن الجلوس في الصفوف الخلفية والاستماع إلى الأغاني. انسحبتُ أيضًا من جماعة المصلّى. وذات مرةٍ شغّلتُ الموسيقى بدل الأناشيد عبر أثير إذاعة المدرسة، فعوقبتُ بشدة. صُدم الجميع بهذا التغيير واحتقروني بسببه.
أخذني الشِّعر إلى عوالم أخرى لم أكن أعرفها من قبل. صرتُ أقضي وقتًا طويلًا بمفردي، أتأمل السماء وأشعر بروحي تزداد اتساعًا وتتواصل مع الرب من دون حواجز
بعد المرحلة الثانوية، طلبتُ إلى والدي العودة إلى مصر من أجل استكمال دراستي الجامعية، لكنّه رفض بسبب تغيّر أفكاري وقناعاتي. كذلك حصلتُ حينها على منحةٍ للدراسة في جامعةٍ محلية، لكنّي رفضتُها في بادئ الأمر، وحملتُ أغراضي القليلة وكتبي والدفاتر التي اعتدتُ أن أكتب فيها الشِّعر، وصعدتُ للعيش في ملحق المنزل. كنتُ في غاية الكآبة، وكنتُ أنهار تمامًا بمجرّد الخروج إلى الشارع ولبس الحجاب مرغمةً وشجاري الدائم مع “هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”.
أثناء فترة عزلتي هذه اكتشفتُ السينما. عثرتُ صدفةً وأنا في صدد تصفّح موقعٍ لتحميل الكتب الإلكترونية على كتابٍ بعنوان “النحت في الزمن” للمخرج الروسي أندريه تاركوفسكي (Andrei Tarkovsky)، وسرعان ما قمتُ بتحميله. ثم بحثتُ عن فيلمه “المرآة”، وبعد مشاهدته، صُدمت بفكرة وجود شيءٍ مماثلٍ في هذا العالم! هذا الفيلم يشبه الشِّعر، ويشبه الصّور التي أراها في ذهني والعوالم التي أنسحبُ إليها.
اكتشفتُ وقتها مصطلح السينما الشِّعرية، ثم بدأتُ بالبحث عن مخرجيها ومُخرجاتها، وغرقتُ في استكشاف السينما الأوروبية. أحببتُ جان رينوار (Jean Renoir) وتاركوفسكي وبيرغمان (Ingmar Bergman) وجان-لوك غودار (Jean-Luc Godard) وثيو أنجيلوبولوس (Theo Angelopoulos)، ثم بنيتُ آمالًا كثيرةً وأردتُ بشدةٍ أن أصنع أفلامًا، لكن كلّ تلك الأحلام كانت تتحطم بمجرد أن أفتح الشباك وأتذكر بأنّي ما زلتُ عالقةً في هذا المكان.
حبال الموت
تدهورَت صحّتي النفسيّة، لكنّي لم أتوقف عن كتابة الشِّعر، والنصوص، والرسائل والقصص كطريقةٍ وحيدةٍ لتهدئة قلبي وتجاوز فكرة الانتحار.
كنتُ أنشر ما أكتبه على إحدى المدوّنات، بالإضافة إلى حسابيّ على فيسبوك وتويتر، ثم شرع أناسٌ كثرٌ يهتمّون بقصائدي، وبدأ يصلني العديد من الرسائل المؤثرة يوميًا. رغم ذلك، كنتُ في غاية الكآبة والحزن، ولم أُرد شيئًا غير الموت.
بعد عامٍ ونصفٍ من عزلتي في ملحق المنزل وكتابتي العديد من القصائد والقصص التي نشرتُها ورقيًا بعد ذلك بسنوات، حاولتُ الانتحار مرةً، فانتبهت عائلتي إلى أن شيئًا خطيرًا يحدث لي. بدأ والدي يقنعني بالالتحاق بالجامعة في السعودية، مشيرًا إلى وجوب أن أتمّ على الأقل سنةً جامعيةً هناك كي أتمكّن لاحقًا من الانتقال إلى جامعةٍ مصرية.
اتخذتُ من مكتبة الجامعة ملاذًا آمنًا، فكنتُ أقرأ حوالي ثلاثة كتبٍ يوميًا، وأكتب الكثير من القصائد وأنشرها على الإنترنت. تنبّه إلى أعمالي العديد من الشعراء، وبدأ بعض الصحافيّين بنشر قصائدي في المجلات والصحف، كما أرسل لي أحدهم ذات مرةٍ رابطًا لمسابقةٍ شعريةٍ تنظمها منظمة اليونسكو في باريس، فقدّمتُ عددًا من قصائدي ثم نسيتُ الأمر، لأفاجَأ بعدها بأيامٍ بفوزي بالمركز الأول عن فئة الشِّعر باللغة العربية!
تدهورَت صحّتي النفسيّة، لكنّي لم أتوقف عن كتابة الشِّعر، والنصوص، والرسائل والقصص كطريقةٍ وحيدةٍ لتهدئة قلبي وتجاوز فكرة الانتحار
لم أكن حينها تجاوزتُ التاسعة عشرة، وكانت رغبتي بالموت فاقت رغبتي بالحياة، كما تفوّقَت عزلتي عن العالم على اشتباكي معه. حينذاك، لم أُرد شيئًا غير أن يدعني الناس وشأني.
بعد أيامٍ من فوزي بالجائزة ونشر جريدة الأهرام وصحفٍ أخرى قصائدي الفائزة، قام أحد مشايخ السلفية في مصر، سعيد رسلان، بقراءة قصيدتي “مرثية إلى نفسي” في خطبة الجمعة، معترضًا على نشر تلك “الهرطقة” في جريدةٍ رسميةٍ ومهدرًا دمي، ثم ذكر بياناتٍ شخصيةً عن مكان إقامتي.
اتهمَتني الهيئة بالإلحاد وبدأَت بالتحقيق مع والدي. لم أكن تجاوزتُ العشرين من العمر حينها، وأدّى ذلك إلى تضاعف اكتئابي وإصابتي بنوبات هلعٍ حادّة. أذكر أن التحقيقات استمرّت لأسابيع، كان يذهب فيها والدي كل صباحٍ ليعود مساءً ويدخل إلى غرفته من دون أن يتحدث إلى أحد. كنتُ أتجنب الالتقاء به لأنّي كنتُ أشعر بالذنب. لم أعرف الكثير عمّا جرى سوى أن أحد معارف والدي تدخل وانتهت القصّة. لم أسَل بعدها عن تفاصيل ما حدث.
العهد الجديد
تغيّرَت حياتي كثيرًا بعد تلك الواقعة. أغلقتُ كل حساباتي وانعزلتُ عن العالم مجددًا. فقدتُ القدرة على رؤية الواقع والتعامل معه، وشعرتُ أن بيني وبين الجنون شَعرة. اعتقدتُ أنّي حتمًا سأفقد القدرة على العودة إلى الواقع، كما سأخسر عقلي لا محالة. لأن انفصالي عن الواقع كان متكررًا، لساعات وأيام، كما أن ارتباطي بالزمن كان ضعيفًا للغاية. فكان يحدث أن أستيقظ نهارًا ولا أعيش في الواقع، بل أتوه في عقلي حتى يحل الليل، دون أن أعرف أين انقضت كل تلك الساعات وإلى أين غبت خلالها. لكن كتابة الشِّعر كانت تعيدني إلى الواقع كلما تهتُ عنه، تأخذ بيدي ويوصلني إلى برّ الأمان، فأعيش اتزانًا نسبيًا لأيام، قبل أن أتداعى مرةً أخرى.
كتبتُ مرةً في “العهد الجديد كليًا” واصفةً هذه الحالة: “والجنون محض حالة، مثل الحب، ومثل الحزن، ومثل المرض، فأنا أُجنّ أحيانًا، وأحيانًا قد أعود، وحين أكون هناك، أكون نفسي، وحين أعود، أكون ما يريد الآخرون. ويشبه الجنون، أكثر ما يشبه، صداع الرأس، لكنه ينتشر في أعضائك كلها، فحين أكون مجنونًا، أشعر بالصداع في قلبي وفي مفاصلي وتحت أجفاني، وحين أكون مجنونًا، أبدأ بالارتجاف من شدته، وأبدأ بالنشيج ويشتد الألم في خلايا الدم، وأرمي برأسي على الحائط فيتهشّم، وألقي بجسدي أمام كل عربةٍ وأجمع أشلاءه، وأعير خوائي لشبق الآخرين فيملؤونه ألمًا صدئًا يشبه ألم الخلق، ويترنّح جسدي بعد كل ليلةٍ وأقول: تؤلمني أعماقي.”
وراء كل قصيدةٍ هناك قصةٌ لم أروِها غالبًا، وبعض القصائد كتبتُها محاولةً التخلص من صورة ساحة الإعدام القابعة في رأسي، والتي كانت تبعد عن منزلنا بضع خطواتٍ فقط. في معرض اتهامي بالإلحاد بسبب تلك القصيدة، قيل لوالدي إنّ العقوبات المحتملة تتضمّن فصلي من الجامعة وجَلدي 500 جلدة وترحيلي. لم أستطع تقبّل أن ينتهي بي الأمر أُجلَد في ساحة الإعدام التي مررتُ فيها جيئةً وذهابًا منذ الطفولة. حين علمتُ بالخبر، كتبتُ قصيدةً بعنوان “لن أصافح أحدًا” وفيها قلت: “لا تقطفني الآن أيها الموت/ يا ملاكي الحاني/ الحياة أبدية/ الأيام كثيرة/ الشمس تشرق كل يوم/ وأوراق التقويم/ أكثر من أن نعدّها/ وحتمًا/ ذات صباح/ سأذهب معك في نزهة/ لكن دعني الآن يا صديقي/ أريد أن أعرف/ كيف أداوي أرقي”.
كتابة الشِّعر كانت تعيدني إلى الواقع كلما تهتُ عنه، تأخذ بيدي ويوصلني إلى برّ الأمان، فأعيش اتزانًا نسبيًا لأيام، قبل أن أتداعى مرةً أخرى
بقيتُ على تلك الحال عامًا ونصف بعد تلك الحادثة، أكتب عندما أوشك على قتل نفسي أو عندما يوشك الواقع على قتلي، إذ كانت فكرة الانتحار تلوح في رأسي طوال الوقت. أقف أعلى الدرَج فأتخيّلني أسقط. تمرّ أمامي سيارةً فأتخيّلها تصدمني حتى أموت. لا يهدأ سيل الأفكار هذا إلا عندما أركض إلى أقرب قلمٍ وورقةٍ في متناولي وأبدأ بالكتابة. كتبتُ قصائد كثيرةً وأنا واقفةً في الطابور أو منتظرةً في حمّام الجامعة. إذا ما أتت القصيدة، لا يهم أين أكون أو ما أفعل، فهي تأتي عاصفةً وتسير بي، إلى حيث تشاء.
أخيرًا، تمكنتُ من العودة إلى مصر. تركتُ كل شيءٍ ورائي، حياتي، وأصدقائي، وجامعتي وحتى قططي الصغيرة. رميتُ بنفسي في القاهرة القاهِرة التي أخرجَتني شيئًا فشيئًا من داخل نفسي، فلم أعد أفكّر بالانتحار. احتجتُ إلى هذه الحياة الصاخبة لأنسى الماضي الذي قدِمتُ منه وأنشغل عن حروبي الداخلية.
يومًا بعد يوم، تمكنتُ من أن أصبح أكثر هدوءًا، لاسيما بعدما بدأتُ بالدراسة في المعهد العالي للفنون المسرحية. وكان ما أوصلني إلى الدراسة هناك شهادةُ تحفيظ القرآن تحديدًا، إذ لم تقبل بها جامعاتُ مصر الخاصة، لكن أكاديمية الفنون فعلَت.
آلاء حسانين
آلاء حسانين شاعرة مصريّة ولدت في السعودية عام 1996، وتقيم في باريس. أصدرت ديواني الشعر “يخرج مرتجفًا من أعماقه” (2018) و”العهد الجديد كلًيا” (2019) عن منشورات تكوين، ومجموعة قصصية بعنوان “حكايات السأم” (2021) عن الهيئة المصرية العامة للكتاب. درست الأدب الإنجليزي في جامعة القصيم. وتخرّجت من قسم الدراما في المعهد العالي للفنون المسرحية في القاهرة. فائزة بجائزة اليونسكو للشِّعر في باريس عام 2015.