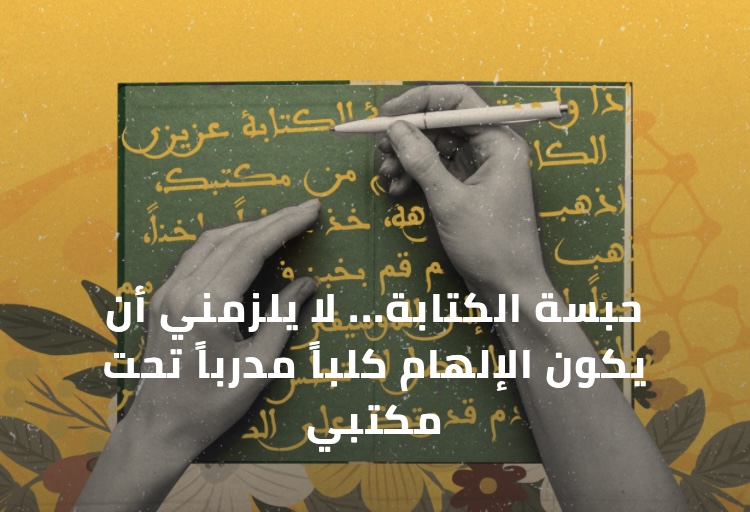لا يستطيع أي إنسان أن ينجو من نفسه – ٢٠١٤
نص قديم، أشبه ما يكون باليوميات. عثرت عليه صدفة بينما كنت أنبش في نصوصي القديمة، كتبته منذ عام تقريبا حينما في الثامنة عشرة، أذكر أني علقت في إكتئاب مريع لعام كامل، عام بأكمله، لا أنهض من سريري ولا أقوم بأي عمل، عام كامل، لم أقابل أي بشر ولم تصافح يدي يد أي إنسان آخر، ورغم أني خرجت من هذه العزلة منذ عام تقريبًا، إلا أنني ما زلت حتى الآن، كلما وجدت نفسي بين حشد، شعرت بالتقزز. إن هذه أنا، هذه -ويا للأسف- طبيعتي، شخص يبغض الناس ويمعن في تعذيب نفسه. لا يستطيع أي إنسان أن ينجو من نفسه.
(يقول مدرس الجغرافيا: في العالم سبعة مليار شخص، فأررد في نفسي بفم مفتوح على آخره وعينين جاحظتين، كعينيّ شخص قد انغرز سكين في بطنه: سبعة مليار شخص وإله واحد!
كل صباح، أجلس على سريري،أو أجلس على الذي أظنه سريري، بينما هو ربما مائدة العالم الشاسعة ..
ومثل بنطال في آخر السرير، ملقى على عجل، هكذا جسدي، أتحرك برئة معطوبة و ثقب صغير في القلب، أتعايش معه، و مازلت مقتنعا منذ طفولتي أن قلبي قد عاش سبعين عاما أو اكثر، أنا متأكد أنه كان في جسد آخر، جسد منهك جدًا، ثم انتقل إليّ، لا يمكن أن يكون هذا القلب، الذي يلهث حين ينبض، ويتوقف أحيانا كثيرة، ثم يدرك أن الطريق مازال طويلا أمام فتى في مثل عمري، فينهض، لأعيش حياتي إلى آخرها، كأي فتى في مثل عمري..
لا يمكن أن يكون هذا القلب في عمر الثامنة عشرة، ولا هذا الجسد الذي يستعد لإستقبال عامه التاسع عشر، بمنتهى الكآبة، مثل إمرأة تدخل عامها الخمسين وتشد وجهها بكل قسوة لتفرد تجاعيده، كأنه قطعة عجين فوق طاولة المطبخ..
ولا هذا الرأس، الذي نبتت في أوله شعرات بيضاء، كأنه سماء مظلمة انقض النهار عليها فجأة، لا يمكن أن يكون رأس فتى في الثامنة عشرة ..
هذه الأيدي، التي لم أقتنع يوما أنها تمتد من كتفي، لطالما كنت أعاملها كأنها أيد خشبية، أو ذراع مبتورة، ما تزال تتحرك لكنها لم تعد تؤلمني، ولم تعد تخصني. هذه اليد التي من لحم وروح وعظام، لم اشعر بها يوما، لطالما كنت أحس بها متورمة على الدوام.. حتى أنني في صغيري كنت أغرس فيها دبوسا وأنزعه دون أن اشعر بشيء. كنت أعاملها كما أعامل قميصا أرتديه، أو كنزة صوفية، أكر جلدي كما أكر خيوطها وأنا أنظر للنافذة غير منتبه لأستاذ العلوم الذي يتحدث دائما عن أشياء لم ارد أن أفهمها يومًا. كنت اعاملها كأي شيء يخصني مثل حقيبة أو مقلمة زهرية أو حتى درج غير مرتب.. أي شيء يخصني، لكنه ليس قطعة مني. حتى صرخت أمي ذات ليلة حين رأتني أحفر بسكين حادة خطوطا على يدي وأتأوه قليلا ثم أرسم بالدم المتساقط دوائر على الطاولة.. أخبرتني أمي أن عليّ أن أتوقف لأن هذا مؤلم. وحين قلت لها: هذا لايؤلمني. أجابت بتأثر: لكنه يؤلمني..
قبل عدة أشهر كتبت رسالة إنتحار طويلة إلى صديقة لي، وكنت أجلس على خشبة عالية في المخزن جعلت منها سريرا بسيطًا، بعيدًا عن ضجة العائلة في الأسفل وإزعاج أمي الدائم.. وقت الغداء. وقت النوم، وأوقات الدراسة.. أسميه ازعاجا لأنه لم يكن غير ذلك.
قلت لأمي: سأعيش في المخزن، لا تسألي عني.. أريد أن أموت وحيدًا. لكنها لم ترد ذلك. لقد ظلت تصعد إلي كل يوم بأطباق العشاء، وقلبها المنفطر كان يترجاني لأعاود العيش معهم في الأسفل.. وسط الإزعاج الدائم، وصراخ إخوتي الصغار، وشجار والديّ المستمر، وصوت الشاحنات في الشارع العمومي، الذي كانت تطل عليه نافذة غرفتي، حينما كانت غرفتي.
لكنني صرخت مرات عديدة. وطلبت من امي أن تكف عن كل هذا، أخبرتها أنني لا أريد طعاما، لا أريد قلبها ولا دمعها ولا قلقها الدائم. لا اريد سوى أن تدعني وشأني. أتذكر أن أمي كانت على وشك أن تبكي، كما كنت أنا كذلك.. لكنها أسرعت للخارج ولم تأت بعد ذلك لعدة أشهر.لكنني كل ليلة كنت أشعر بيدها تفرد الغطاء فوق جسدي وتطبع قبلة على جبيني ثم تتسلل بسرعة قبل أن أستيقظ لأن نومي كان خفيفا جدًا حتى أنني كنت اصحو بمجرد أن تتحرك الستائر لأن نسمة خفيفة مرت أمامها وألقت عليها التحية.
ذات مرة كنت أجلس على سريري الذي كان في الأصل قطعة خشبية موضوعة على كراتين مرصوصة فوق بعضها. لم أعرف ماتحويه يوما. جلست هناك فوق السرير الذي كنت أظنه دائما مائدة العالم الكبيرة. كنت أحبه لأنني كنت حين أرفع يدي كانت تلامس السقف وكانت النافذة كبيرة ومفتوحة على الدوام، وكنت أحب دائما أن أتأمل السماء الشاسعة وأضواء المدينة الكبيرة التي لا أحب فيها أحًدا ولا شيئًا سوى عمود إنارة وحيد كنت اتخيله دائما نجمة متقاعدة..
كنا في إجازة الصيف وكانت الأيام تمر دون أن ينتبه أحد لمرورها.. لكنني ذات مرة أدركت انني لم أخرج من غرفة المخرن هذه منذ تسعة أشهر. لم أقابل أحدًا ولم أكن أشعر بشيء سوى بالوحدة المؤلمة. حتى أني كنت احيانا أطوي قدميّ وأحوط ذراعيّ حولهما وأجلس في وضعية تشبه وضعية الجنين، ثم آخذ بالإرتجاف من شدة الوحدة.. لكنني لم اكن أحب أن اشعر بشيء غيرها. تقول أمي أنني أمعن في تعذيب نفسي.
لا أعرف. ما تسميه تعذيبًا أسميه أنا شعورا باللذة.. الجميع يظنني شخصا غريبًا، ما عدا أمي.. لقد كانت تظن بأن الجميع غرباء. وكانت تردد هذا الكلام على مسمعي دائمًا، رغم أني لم أكن أشكو من شيء تجاه ذلك.. لكنها كانت تقول ذلك
تحسبًا لأي وقت عليها أن تقول فيه هذا الكلام حين أعود إليها منزعجًا أشتكي من أن غريبا ما وصفني بالغريب وهو يتفحصني بعينيه وينظر لي من أعلى لأسفل.. لأنني لا أمشي كما يمشي الجميع، لا أهز رأسي كما يهز الجميع رؤوسهم، ولأنني لا أمتلك حيوانا أليفا..وربما لأشياء أخرى أهم من هذه، أشياء أحرص دائما ان أتجاهلها لأنني متأكد أنني حين أمعن في التفكير فيها سوف لن أكف عن وصف نفسي بالغريب.. وكانت أمي لا تكف أيضًا عن وصف الجميع بالغرباء، وكنت أصدقها. خاصة عندما تتنهد مثل بحر يبكي..
ما زلت أتذكر رسالة إنتحاري الأولى التي كتبتها ذات مساء حين انتفضت فجأة مثل ذئب وقع في الأسر، لمّا نظرت إلى السماء ذات ليلة وقررت حينها أن عليّ أن أنتحر بسرعة.. لا أعرف ما في السماء يدعو شخصا ما للإنتحار لمجرد أنه نظر فجأة إليها.
اخذت أكتب إلى ريتا كمن ينتزع الأشواك من حلقه. كانت ريتا الشخص الوحيد الذي كنت لأرغب أن أحدثه لو كنت اعيش آخر يوم في الدنيا.. كنت أكتب لأنني كنت أشعر بشدة أنني أريد أن أنتحر، لكنني حين انتهيت شعرت أنني لا أريد سوى أن أنام وحسب.
المضحك أن الجميع علم فيما بعد بأمر الرسالة. ما عدا ريتا
حتى الآن، ريتا لم تعلم أن هذه الرسالة أنقذتني وأن صورتها الضاحكة في ذاكرتي جعلتني أشعر بشيء من الرغبة في الحياة. ريتا لا تعلم مايدور في ذاكرتي، لكنها تؤمن بي.. وتخبرني دائما أنها تحب شغفي بالحياة، لكنها ايضا لا تعلم أنني أفكر بالإنتحار أكثر من عدد الشتائم التي نتبادلها كل يوم، وأن الشيء الوحيد الذي يضرب هذه الأفكار على رأسها بعصا خشبية ثقيلة تشبه عصا العساكر في المظاهرات التي أراها من نافذة منزلي.. الشيء الوحيد الذي يضرب أفكاري
حتى يغمى عليها قليلا قبل أن تفيق مجددا وتسيطر علي من جديد.. هو صورة ريتا التي تضحك ملأ فمها بكل هذا الألم المتراكم في عينها.
ريتا لم تكن تضع عينها في عيني أبدًا، لأنني كنت اقرؤه، هذا الحزن داخل عينيها الجاثي على ركبتيه مثل ثعلب يائس لكن ماتزال لديه القدرة على الإنقضاض على أي أحد في أية لحظة. كنت أرى في عينيها أيضا جثث كثيرة قفزت لداخلها أثناء الحرب وأشواك منغرسة تحت جفونها كدبابيس مغروزة في وسادة صغيرة.
كنت أعلم أن أسوأ شيء لريتا كما هو أسوأ شيء لي: البكاء أمام أحد. لذلك كانت تضحك عاليا بينما تبعد عينها عني بسرعة خاطفة. وكنت أضحك أيضا.. بينما أزيح أنا كذلك عيني للجهة الأخرى كي أقنعها بطريقة غير مباشرة أنني لم أنتبه أبدا للدمع في عينيها، ثم أحاول طمأنتها من خلال ضحكة أعلى بأنني لن أتصرف بأنانية وأغرز شوكة سؤالي عن حالها في قلبها، المشابه لقلبي، والممتليء بالحزن كبالون ينتظر أي نسمة هواء تكون خشنة قليلا لينفجر..لذلك لم أكن اسألها عن حالها ابدا .
و قبل أن تبهت ضحكاتنا كنا نسارع دائما بوداع بعضنا، محافظين بصعوبة بالغة على ابتسامة عرجاء فوق شفاهنا.. ثم ننزوي على أنفسنا مجددًا.. هي في غرفتها، وأنا في المخزن- الذي حتى هذه اللحظة مازال غرفتي – لنبكي في وقت واحد ولأسباب مجهولة أيضا.. كنت أحب في ريتا حزنها السري الذي كانت تحبه فيّ أيضا، بالإضافة لما تسميه شغفا بالحياة رغم أنني لم أعرف يوما كيف تكون الحياة. حتى أعرف كيف يكون الشغف.
آلاء. 18 سبتمبر 2014.