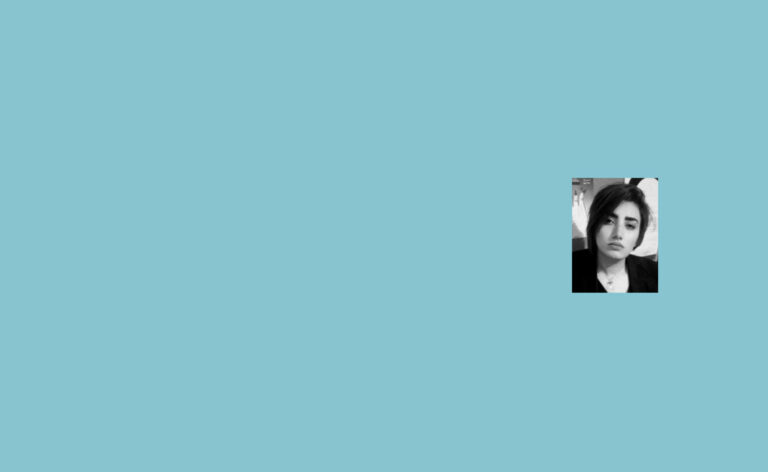“المدينة ستُتعبني”: أربع شاعرات في مدن لا تخصهن

منشور الاثنين 30 مايو 2022
قد تكون قصيدة قسطنطين كفافي فالمدينة ستتبعك أحد أشهر القصائد التي أعيد تأويلها فنيًا وشعريًا وسينمائيًا، وبشكل شخصي، امتزجت هذه القصيدة بوجداني زمنًا طويلًا.
لا أستطيع أن أنسى عندما كنا نوضب أغراضنا في الحقائب، حتى نغادر المدينة التي ولدنا وتربينا فيها. ولا أظن بأني، أو أحد أخوتي، نجحنا في الانتماء إليها. وشخصيًا كنت أشعر بأن تلك المدينة الصغيرة في قلب نجد، تغربني كل يوم أكثر فأكثر. حتى تجهزنا للمغادرة ذات يوم بعد أكثر من عشرين عامًا، وقتها كنت قد قرأت قصيدة قسطنطين تلك وعلقت في رأسي، وفي لحظة قلت لإحدى أخواتي “تعرفين أن قسطنطين كتب ذات مرة قصيدة يقول فيها: فطالما خربت حياتك هنا، في هذا الركن الصغير من العالم، فهي خراب حيثما رحلت؟ لكنها اندهشت وشهقت ثم قالت: لا إن شاء الله”.
وظلت كلماته التي تؤكد بأن المدينة ستتبعني تلح على رأسي، حتى عندما انتقلت للقاهرة وامتلأت بكل زاوية فيها، ظلت مدينتي القديمة تحدق إليّ من بين الأعمدة والكؤوس.
هل هذه مدينة أم نصل؟
دفعني الفضول إلى سؤال شاعرات عربيات عن مدنهن، وعلاقتهن بها. عن هذا الارتباك اليومي، عن التآلف والتخاصم مع ضوء المدينة وطريقها وريش حمامها/حجارتها، المتساقطة.
وصفت إيناس سلطان، وهي شاعرة من غزة لها قيد الكتابة مجموعة شعرية بعنوان عليكِ أن تمسكي السمكة الناجية، مدينتها بأنها “مدينة ميتة، لا تدعي عكس ذلك” وبالعودة إلى قسطنطين ومدينته، تقول إيناس: “هذه القصيدة خلاصة رائعة ومباشرة، لكننا لا نستطيع تطبيقها أبدًا على مكان مثل غزة. المكان الذي ولدت فيه، وكبرت فيه، ولم أغادره حتى الآن.
وأوضحت: لنأخذ بخلاصة كفافيس علينا أن نكون من الأول في مكان قابل للتخريب، وهذا شرط أوليّ للمكان الذي يقصده كفافيس. على المكان أن يتوافر فيه ما أُسميه أنا، الحد الأدنى من المكان، وغزة للأسف، خارج هذا الحد أصلًا.
وعلاقتها بغزة ملتبسة، ومشحونة، وفيها من التقارب والتباعد الشيء الكثير، فتصف إيناس هذه العلاقة قائلة: لم تكن قط علاقة عادية بين إنسان ومدينته. كانت علاقة سجين بسجين آخر أقدم منه، وأعرَف منه في شؤون السجون.
تضيف: غزة سجينة العالم، وأنا سجينتها، وهذا الدور الذي أرغمتني عليه وسايرته للآخر، أوصلني سريعًا إلى ما أسماه أنسي الحاج: آخر الخوف، الذي لا هو استسلام ولا هو شجاعة، بل بطولة التعب. بطولة من استنفد طاقته على الرعب. غزة جعلتني لا أخاف شيئًا في العالم، وهذا يْحسب لها.
غرفة تخص المرء في مدينة لا تخصه
تقفز إيناس من المدينة الصغيرة إلى الحجرة الكبيرة وتقول”صحيح أن لدي غرفة تخصني وحدي، وتشبه إلى حد ما غرفة فيرجينا وولف، لكن هناك دائمًا هذا الشعور أن غرفتي مبنية على ظهر حوت. وفي أية لحظة ستقع الغرفة وأغرق. أريد أن أعرف ما فائدة أن يكون لديك غرفة تخصك وحدك في مدينة لا تخصك؟”.
تستطرد “قبل سنوات، تعدت الخمس، كنت حائرة وغضة، ولكن لايزال فيّ نفس. كنت أخرج كثيرًا إلى الشارع مع أصحابي، الذين توزعوا الآن في بلاد بعيدة وباردة. وقرروا نسيان غزة بكل ما فيها، حتى أنا. كانت نزهتنا تعني المشي في الشوارع، ورصد وجوه العابرين، وتخمين أفكارهم وشخصياتهم من ملامحهم، نقول مثلًا هذا لو تكلمنا معه سيلعن والدينا، ونضحك”.

وعلى ذكر الضحك تتذكر إيناس تلك الشوارع المضحكة، كما تسميها، فتقول “صحيح إن شوارع غزة عشوائية، ولا تنم عن ذوق محدد، غير أن هناك شوارع أليفة وحيوية، هناك شوارع مضحكة، مضحكة بالفعل وحين أتذكرها أضحك. وهناك شوارع حيادية، غير مثقلة بتاريخ غزة الدموي، وهي قليلة جدًا بالمناسبة. لكن الغلبة لشوارع الشهداء، تقريبًا كل شارع في غزة له اسم شهيد. ويشبه الشهيد في حياته”.
“بيوت غزة أيضًا متنوعة، أغلبها ممل، وغير ملهمة بالمرة، عدا بيت واحد. بيت ضخم ومهجور، في شارع متروك للريح. له واجهة مريبة، يسد مدخله شجرة زنزلخت ضخمة، وأشجار أخرى. وباب كبير وعدائي، فور أن تنظر إليه، تشعر أنه سينقض عليك” تتابع الشاعرة.
وفي كل مرة تمر برفقة صديقتها على هذا البيت تقول لها: “اكتبي عن هالبيت”، وتعلق إيناس “هذا البيت سيدخل لاحقًا في قصائدي، وما عدا ذلك ليس لدي الكثير لأقوله عن علاقتي بغزة. أنا الآن لا أخرج من البيت إلا للضرورة. وهذا قرار يعرف أسبابه كل العالم، أعتقد ذلك”. واختتمت حديثها بيت محمود درويش “آه يا أصحاب، لا شيء يثير الروح في هذا المكان”.
من غزة إلى اللاذقية: مدن من رصاص
عند درويش ختمت إيناس حديثها، وعنده أيضًا بدأت الشاعرة والكاتبة السورية مي عطّاف حكي علاقتها بمدينتها اللاذقية في سوريا.
تقول مي “منذ عشر سنوات ألاقي الفجر كي نسير معًا عبر شوارع المدينة، الشوارع التي أريد أن أردد نداء محمود درويش وبتصرف هذه الشوارع لي، أريد منها مقايضة ذاتي لأشعر أني لها، كأن تشير إلي وتنشد هذه المرأة لي، لكنها لم تبادلني بيت القصيد. وكنت أشعر أنني النهر الذي لا بد أن تصبه للبحر، وتترك لي احتمالات الغرق والنجاة”.
وكما حدث مع إيناس ومعي، أثار ذكر المدينة موطن الأوجاع عند مي، قالت “في قرية صغيرة قال عني أحدهم: ملعونة أنتِ، فقط لأني قلت أني والله حبيبان.. أن يخرج الكلام منك كأنه يحتاج لترجمة، ثم ينعتوني بالمتفزلكة لأن الكتاب حل بين أضلعي كرفيق للقلب.. سموني بالمجنونة لاختياري، عن سابق راحة، الوحدة”.
تضيف: كنت أقرأ لسعد الله ونوس بلاد أضيق من الحب، ورحت أستشعر الضيق في النظرات المرتبكة بين حبيبين… من خوف رجل قال كلمته… من الشوارع التي يمثل فيها الرجل عمود إنارة لا لينير بل ليراقب. أعبر شوارع المدينة فجرًا وأدندن كما قال شوقي بزيغ تقيم بيننا وبين جلدنا، ولكن بأي شكل تقيم المدينة بي؟.
أحمل حقيبة ظهر بها دفتر وقلم وكتاب، وللغرابة أن يكون غرفة تخص المرء وحده، لفيرجينيا وولف. يالها من مفارقة أن أحمل غرفة فرجينيا على ظهري، وأن أخبرها أن غرفتي التي تخصني، هي مفتوحة على النداءات اللحظية حتى لو أتممت واجباتك البيتية على أتم وجه. وأني كجمل أحمل زوادتي والوقت الذي تكون المدينة نائمة فجرا فهو الوقت الخاص بي. وقت لا يتجاوز ساعتين”.
يسألونني: مكان ولادتك؟ فأجيب اللاذقية. ثم تتابع مي واصفة مدينتها: مدينة البحر والجبال والسماء الزرقاء وخضرة الجبال والأنهر. يالهذا المكان الجنة، سيجيب السائل، وسأوافقه أن اللاذقية لكانت جنة لولا أن سوروا البحر، وحرقوا الغابات، وصار الوطن فيها جار يرمي كل صباح قمامته أمام بيتي، فأكنس قمامته وأنا في طريقي لقضاء حيز من عمري في الوقوف في طابور للحصول على رغيف خبز.
“وطن يطلق الرصاص متى شاء” وكأن هذه طريقة وطن مي لإلقاء التحية على بنيه. تسرد: ابتهاجًا وحزنًا وعراكًا تحت نافذتي. وربما يتشظى زجاجك برصاصة سموها طائشة. فهي لم تعِ بعد أن لا حق لها أن تصبغني بلونها. وللأمانة لا تأتي الرصاصة على شكل معدن، لربما تأتي على شكل عبارة، فتحيلك لشخص أشبه ببركان قد سدت فوهته والتوتر يغلي بقاعك.
ولا يذكر أحد المدينة دون أن يمر بغرفته، تقول مي “في غرفتي تزدحم الشخصيات التي تقفز من رأسي لتحط على سريري وطاولتي وفوق الخزانة وفيها. شخوص تقف تتأمل قرب النافذة وشخوص تقف قرب الجدار يسندها من الوجع. وكلها تصرخ بي: امسحي الورقة بالقلم كفانوس، فقط أخرجينا من غرفة لم يعد فيها مكان للجلوس والاستلقاء، وأهمُ في مسح الورقة، لكن الكهرباء.. نعم الكهرباء تسحبني أن أسرعي في عمل البيت. لا وقت لديك فلن أمكث سوى أقل من ساعة. ولا تنسي أن تجلي الأواني على عجل خوفًا من انقطاع الماء. واغلي قهوتك على عجل على السخان واركنيها على جنب، لا بأس بشربها باردة. ولكن أسرعي وضعي الطنجرة على السخان. أيضًا لا بأس لو أنجزت نصف طبختك لتوفري قليلًا من الغاز الذي لن تحصلي عليه إلا بعد ثلاثة أشهر”.
تتابع “أقرأ فرجينيا وولف في غرفتها التي تخص المرء وحده، وذاك الطقس من الشموع والنور والدفء والحمام وأتنهد.. ماذا لو كنت في مدينة لبلد آخر، وأحلم بالنهوض فجرًا، وعلى مهل يعم بيتي دفء. أصنع قهوتي وأركن لجوار طاولتي، أمسح على رأسي بهدوء وتنزل الشخصيات على مهل على الورقة”.
الهرب نحو ما يُدعى ” القاهرة”
وبين حلم المدينة الذي لا يتحقق لمي، وذكرى المدينة التي تُذكر بكلمة “نعم” و “حاضر”، تنقلنا الشاعرة المصرية هاجر سيد، والتي لها تحت الطباعة مجموعة شعرية بعنوان ذاكرة معطوبة ولغة من ليمون، إلى مدينتها في محافظة البحر الأحمر.
تقول هاجر “كرهت كل شيء في سن صغيرة، شعري، جسدي، مخي الصغير كدجاجة، وكلمة نعم وحاضر والمدينة التي أنتمي إليها”.
طفلة تنحدر من عائلةٍ كبيرةٍ لها نسبٌ ممتد حتى السعودية، متدينون للغاية. ولكن لم يدفعني والدي إلى العبادة عمدًا ولم أُقبل على الصلاة إلا اذا أردت شيئًا من الله، كأن يتركني أبي أُفكّر في الخروج من حدود المدينة مثلًا، تضيف هاجر.
وتتابع “أسرة كبيرة العدد، حيث لا وقت لديهم ليركزوا فيما أقول أو آكل، يفترض أن كلًا مشغولٌ في ذاته، لكن العكس تمامًا، لدرجة أنهم يوشكون أن يفكرون مكانك، يختارون ماذا تأكل وأين تعيش وتجلس؟”.
تعلقت هاجر بحلم الهروب من المدينة، تقول مثلًا أن: كل ما تعرفه والدتي أن القاهرة في القناة الأولى على التلفاز حيث إقامة شعائر خطبة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي، من ثم يسافر أبي ليومين عمل ويعود، يحكي لي عن الشِعر والشعراء وأوساطهم الأدبية وعن طبقٍ من حبايب السيدة. كنت أتخيل نفسي أجلس في أحد مقاهي وسط البلد أمسك كتابًا وفي اليد الأخرى فنجال قهوة حرة التعبير والشخصية تمامًا ثم أضحك وأقول إنها مسألة وقت لأخطف نفسي والهرب نحو ما يدعي القاهرة.

كنت أرقص فعليًا أمام المرآةِ، حول جسدي، داخل جسدي وخارجه، كنت كالباليرينا أرقص على قدمٍ واحدة وأسحب كل ما يتحرك حولي كأنني مكنسة كهربائية وأبلوره لقصائد تُشبه القاهرة. الانتقال من قرية صغيرة إلى قرية أكبر لن يشكل فارقًا سوى أنني تركت أهلي في صندوق مقيّد ورقصت على القفل. لذا كانت القاهرة الوجهة الثاقبة، تحكي هاجر.
وعودًا إلى المدن المتخيلة، تضيف هاجر “كنت أتخيل نفسي أشياء كثيرة للهرب، كل أدوات الهرب، كل ظروفه، تخيلت أنني شنطة يد صغيرة لأم تذهب للسوق، عصفور، حالات كثيرة عدا نفسي، لدرجة أنه نشأت غيرة بيني وبين النافذة، بين الفراغ الذي لا يقربه أحد. كنت أقلّد الطيران، أقلّد الزحف، أجرّب القفز فوق كل شيء وحين تحين اللحظة سأنقلب طائرًا جارحًا لخطف نفسي والهرب”.
تعقدت علاقة هاجر بمدينتها أكثر حين صعب الفرار منها “رفض والدي كان قاطعًا في انتقالي إلى القاهرة، بحجة أنني فتاةٌ وناعمة ويدي تنفلت من حمل أكياس القمامة، ولا أقوى على فعل شيء سوى التفنّن في البكاء”.
أرى أمي تحمل المفاتيح، متجهةً نحو الباب، تخرج عادة للسوق، ولا اعرف كيف سأقوى على أن أكون مفتاحًا لكالون مدينة. تمنيت أن أكون مفتاحًا بالفعل، أن أنغرس في كالون الباب وأهرب، أن أنكسر ف القفل ويضطروا لتغييره واقع أنا في معدات التصليح القديمة وأهرب من هناك أيضًا، لدرجة أنني تمنّيت أن أكون هواء لأمر من ثُقب الباب دون هرب، أو عصفور لديه القرار الدائم أن يقف على النافذة ويطير حيثما شاء هذا معنى الحرية، أن تفعل ما شئت وقتما تكون قادرًا على فعله ولا تفعله.
لم تتحول هاجر إلى مفتاح، لكنها كتبت:
رأسي حُر كالطائر
جسدي مغطى بالملابس،
ككعكة شيكولاتة
في حوائط لا عُلبة هدايا
منزلٌ،
كالحبس الانفرادي
أنظر لسماء أسمنتية
ومن النافذة التي تطل على العالم،
تنبشني
أصابع الحُرية
ككومة القشّ
تلمس أفكاري كالجسد
في ليلٍ خريفي
أكون فيه شمعةً
ولا أجد من يُشعلني“
ولما لم تستطع هاجر الانتقال للقاهرة صنعتها في قصائدها، تقول “فكرت طويلًا في المأوى، في البيت، وفي القاهرة كنت أجلس فوق بيوت الشعر وعندما تسقط القافية، أكتب دون كبت. كانت أمي تهد كل ما ابنيه بالألعاب الافتراضية التي تمثل المنزل والحياة الخاصة، كانت تعدل الكرسي، وتكنس الأرضية وتلملم الورق، وتلقيه في القمامة قبل أن آخذ كفايتي من الطمأنينة وتخيل شكل المدينة. لم يكن لعبًا، كانت مشاعري”.
أن يكون وجودك مستفزًا
تصف هاجر استفزازُ وجودِها “كل ما ألمسه يغضب أمي، كل ما أفكر به يستنفر منه أبي، فتوجهت للشِعر، ولم تعد قدمي ثابتة على الأرض، ودائمًا ما أحلم أنني أطير”.
تحسستُ قائمة معارفي الإلكترونية، عالمي الافتراضي، منصَّة الشعر الحديثة، كنت أكتب وأنا أحلم بالمساحة للكتابة، ومدينة لأستمد منها الإلهام، تعرفت على الكثير من الأصدقاء، كوّنت روابط قوية، أرى الشاعرات تهاجرن، يمتلكن مكانة في الشعر وفي البلاد، لديهن كتب، لديهن شيئا خاصًا وأنا لا أملك حتى غرفتي وأحلم دائمًا أنني أملك مدينة، تواصل هاجر.
وتصف تجربتها بأنها: فكرة أتت من الضيق، من انعدام الخصوصية، من المكان الصغير للمكان الحُر، من القيد العائلي إلى الهجرة الجسدية لمكانٍ آخر كي أعيش وأكتب.
تضيف: أحسست بالحزن وأزداد الأمر سوءًا، ضجيجٌ عالٍ، تيلفزيون، ستة إخوة، ومنضدة وقلمي ينام هناك. ذهبت لأبي أشكوه ضجري، بابا “أنا مش عارفه أكتب، صوتكوا بيقطع حبل أفكاري بسكينة تالمة” ضحك وكان رده “هي دي حياتنا”.
تتابع “لم أجد فرصة أفضل من هذه لكي أفاتحه في موضوع الانتقال، انتفض من مكانه، وأخبرني أن أكمل غسيل الصحون لكي أساعد أمي. لم أستوعب كيف يمكن أن أظل طيلة حياتي في مدينة واحدة، وأنا لدي حذائين؟ وأحلم برأسين؟ ماذا يعرف أبي عن المسافة والاستقلال وعزلة النفس وكتابة ما تشعر وأكل ما تكتب ومن ثم تغوطه؟ ماذا يعرف أبي عن عملية الكتابة ومراحلها وطقوسها؟”.
بعد أربع سنوات متواصلة من الدراسة، أيام هائلة وتقلبات مزاجية صغيرة وأهداف مشتتة، ومجال عمل لا أطيقه، وبعد سنوات أدرس وأكتب أدرس وأكتب أدرس وأكتب، وقفت لأبي كقصيدة نثر وسط ديوان مقفى، كخناقة بين شعراء الوزن والقافية أمام النثر، كنت أترجاه كأنه آخر يوم في العمر للمحاولة، أريد أن أسافر لمكان مفتوح، مساحة عريضة للتفكير والمحاولة، أريد حياتي يا أبي، ظل يرفض مرارًا وتكرارًا وينظر ليدي التي ترتعش، وأنا أمسك القلم ماذا ستفعل في شوارع القاهرة؟ وبعد كتابة أول ديوان تركني أبي أذهب كاعترافٍ واضحٍ بنثريتي وسط الشِعر.
ولابد أن نعرج حتمًا على حسين البرغوثي ومُدنه، فحسين الذي كتب: الصوت كان لغيرنا.
يصف مدائنه:
وفي المدن الغريبة كنا نشتري سرب الحمام
لنطلقه في الطريق الذي سوف نسلكه،
لم نجمع المال حتى نقول:” اغتنينا”
ولم نملك الأرض أو ندّعي ملكها
كي نقول:” انتمينا” لأرض أو بلد.